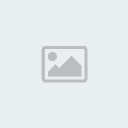تخيّل أن دولة مثل سوريا تعيش أزمة وتجد اقتصادها بين مستثمرين حقيقيين هربوا بالفعل من البلاد ومستثمرين 'شبيحة' هرّبوا أموالهم وبقوا هم.
"عندما تتلقى قبلة من سارق، قم على الفور بإحصاء أسنانك"
مَثَل لاتيني
في سوريا الاقتصاد يتداعى، وفي أحسن الأحوال يتجه نحو المجهول. في سوريا، "رجل أعمال" يعلن عزمه على التوجه للعمل الخيري، ليس زهداً، بل خوفاً. في سوريا، هرب المستثمرون رعباً، لأن مصير غالبية استثماراتهم، مرتبط بمصير السلطة، لا الأمة. والحقيقة أنهم لم يقرروا هذا الترابط المصيري، بل قُرر لهم. في سوريا، الأموال المنهوبة لا تدخل ولو لدقيقة واحدة في الخزينة العامة. في سوريا، أولئك الذين "عُينوا" بمناصب رجال أعمال، يبحثون عن بلدان أخرى، يقبلون بأي توصيف لهم فيها. في سوريا، رجال الأعمال التقليديون –غير المُعينين- يجلسون على الحائط، يرمقون جهة اليمين حيناَ وجهة اليسار حيناً آخر، ليقرروا إلى أي جهة سيقفزون. في سوريا، تم رفع الرواتب، في حركة امتصاص بائسة للغضب الشعبي، لتدخل البلاد في نفق، يستحق عنواناً على شكل سؤال: هل ستستطيع السلطة دفع الرواتب أصلاً؟ في سوريا، بوادر العصيان المدني تتعاظم، في ظل عمليات قتل لا تتوقف للمتظاهرين السلميين. في سوريا، توقف تصدير المنتجات، لتبدأ عمليات تصدير بشري على شكل نازحين ولاجئين، لأول مرة في تاريخها. فقد تحولت من مستقبِلٍ أزلي للاجئين إلى مُصدِرٍ لهم! لم تزل هذه "المنتجات" في مرحلة ما دون "الصناعة"، لكن الأمور تتجه إلى تحولها لـ "قطاع صناعي" جديد على البلاد وأهلها، وعلى دول المنطقة وشعوبها، من فرط القمع القاتل. في سوريا، مجهول مسيطر، على البلاد والعباد والاقتصاد، رغم أن "عنوان المكتوب" واضح، سواء أكان بريديا أم الكترونيا، أو حتى عن طريق الحمام الزاجل. وربما من المناسب الإشارة هنا، إلى أن قانون الطوارئ –السيء الصيت- الذي حُكمت به سوريا أكثر من 48 عاماً، كان يمنع تربية الحمام الزاجل، ويعرض المربين للسجن الطويل جداً! وربما من أجل ذلك يقتلون الحمام!
قبل المظاهرات الشعبية العارمة، عاشت سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمن، في ظل "اقتصاد الفقر وما دونه". وقد أطلقت عليه توصيف "اقتصاد التشبيح". ولأنه كذلك، فقد أصبح بسرعة شديدة، في مهب الريح في أعقاب انفجار الغضب الشعبي. فليس غريباً أن تتوقع جهات محايدة رصينة –لا مندسة ولا متآمرة- إفلاس الاقتصاد. بل الغريب أن يكون هناك من يقول عكس ذلك. جريدة "الفايننشال تايمز" البريطانية، لم تكن متحفظة عندما قالت: إنها تتوقع انهيار الاقتصاد السوري، مما يعني إفلاس النظام-السلطة ورضوخه. وأنقل على الجريدة الرصينة: "أن سوريا ستضطر في نهاية العام الجاري، للبحث عن مساعدات اقتصادية خارجية للحفاظ على اقتصادها، في ظل التدمير الذي يعاني منه قطاع السياحة نتيجة الاضطرابات، وتوقف الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الإنفاق الحكومي للمساعدة في تخفيف حالة الاستياء الشعبي". ويمكن أن نضيف إلى ذلك، أن احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري تستنزف على مدار الساعة، الأمر الذي خفض من قيمة الليرة بنسبة 15 في المائة أمام الدولار الأميركي. ومع كل يوم يمر هناك تراجع جديد لقيمة العملة الوطنية. في خضم ذلك، رفعت منظمة التعاون والتنمية، مؤشر الخطر لسوريا من 6 الى 7، وبدأت الدول الكبرى في الطلب من رعاياها مغادرة البلاد، وهو مؤشر –في المفهوم الاقتصادي- يدل على أن الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ.
لم تكن حالة الاقتصاد قبل الثورة الشعبية أفضل، لكن حالة الدولة كانت مستقرة، مما دفع بعض الجهات الاستثمارية العربية والأجنبية لإنشاء أعمال لها في سوريا، بعد أن قبلت بمشاركة قسرية من رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، الذي يُعتبر بمنزلة "مصرفي" العائلة الحاكمة. وقد وقعت هذه الجهات بأزمة حقيقة، عندما اكتشفت أن الدولة التي تبدو مستقرة لفترة طويلة، لا يمكن أن تستمر هكذا إلى الأبد، إذا لم تكن عناصر الاستقرار متكاملة. هذا "الاستقرار" اهتز في سوريا - كما في تونس ومصر وليبيا - مع أول صرخة شعبية تطالب بالعدالة، ولم يلبث أن انتهى في غضون أيام. وعلى الرغم من حنكة المستثمرين في الحفاظ على أموالهم، وعدم التضحية بها والخوف عليها، إلا أنهم – على ما يبدو - يقعون في نفس الفخ دائماً. حدث هذا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في بعض دول أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، التي كان حكامها يتغنون باستقرار بلادهم، في تسويق ليس من أجل جذب الاستثمارات، بل لمشاركة الحكام فيها. ويعترف – على سبيل المثال - تيودور روزفلت العضو المنتدب للاستثمار المصرفي في "باركليز كابيتال"، بالخطأ التاريخي الذي يقع فيه المستثمرون في الدول التي تبدو لهم مستقرة. ماذا قال؟ "سوريا كانت تبدو كأنها دولة مستقرة تبدأ في محاولة التحديث، لكن التفاؤل الذي حمله البعض بشأن سوريا كان في غير موضعه فيما يبدو". ويمضي أبعد من ذلك ليقول: "ما يحدث في سوريا الآن مقلق للمستثمرين. إننا نشهد حكومة تقمع شعبها"، مشيراً إلى أن المستثمرين، قد يُقبلون مرة أخرى، إذا ما خرجت سوريا من هذه الأزمة "بمؤسسات مدنية قوية وتطبيق حكم القانون".
المستثمرون الطبيعيون هربوا بالفعل من سوريا، بعد أسابيع قليلة من بدء الثورة فيها. أما المستثمرون الجدد الذي عُينوا في "مناصبهم" الاستثمارية، لم يهربوا بعد، ولكنهم هَرَبوا أموالهم إلى كل الجهات الممكنة، لأن هناك أماكن كثيرة في العالم، لم تعد تمثل للأموال المنهوبة ملاذات آمنة، ولاسيما في الدول الغربية، التي سنت مجموعة من القوانين بتجميد أرصدة وممتلكات 23 شخصية سورية متنفذة (وفي مقدمتها بشار الأسد)، وهي تدرس الآن توسيع نطاق هذا التجميد.
ليس غريباً أن ينهار الاقتصاد السوري، بل الغريب أن يستمر صامداً تحت وطأة الحركة الشعبية لفترة طويلة. فكيان هذا الاقتصاد لم يقترب كثيراً من المعايير المؤسساتية. والشيء الذي لا يُبنى وفق هذه المعايير، محكوم عليه بالخراب أو الزوال. وحسب تقديرات معهد التمويل الدولي فإن الاقتصاد السوري سينكمش بمعدل 3 في المائة خلال العام الجاري بسبب الاضطرابات، بعد أن كان قد حقق نموا بنسبة 4 في المائة العام الماضي، ويرجح مراقبون مستقلون أن ينكمش أكبر من ذلك بكثير. وطبقاً لمصرفيين في سوريا، فإنهم رصدوا هروباً للأموال خلال الشهرين الماضيين، بينما أعرب مودعون سوريون علانية عن قلقهم من إيداع مبالغ كبيرة في القطاع المصرفي الوليد، مفضلين إيداع أموالهم في بنوك معروفة في لبنان أو أماكن أخرى. ويقول عبدالقادر دويك رئيس بنك سوريا الدولي الإسلامي (وهو الفرع السوري لبنك قطر الدولي الإسلامي)، إن المودعين سحبوا في غضون أيام، ما يعادل 680 مليون دولار أميركي من بنوك خاصة، وهو ما يمثل 7 في المائة من إجمالي الودائع بهذه البنوك منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
أمام هذه المعطيات، لا توجد مخارج أمام الاقتصاد السوري للنفاذ إلى مناطق آمنة. كما لا توجد بدائل أمام النظام فيها للحيلولة دون وصول هذا الاقتصاد إلى حافة الهاوية. وأحسب أن المسؤولين في دمشق، فهموا هذه الحقيقة، وعرفوا أنه حتى طلب المعونات والمساعدات في ظل الحالة الأمنية الراهنة في البلاد، هو شيء من الخيال، في واقع محلي يبدو خيالي لعدد كبير منهم.